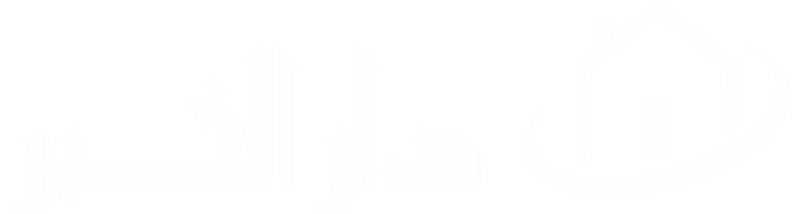يمر المغرب اليوم بمنعطف حاسم في تاريخه السياسي والاجتماعي، منعطف تبرز فيه مفارقة صارخة لا يمكن التغاضي عنها: دولة تتحرك بدينامية متسارعة ونخب غارقة في الرتابة والانتظارية. وبينما تمضي المؤسسة الملكية بخطى ثابتة نحو تحديث المشروع الاجتماعي وصياغة نموذج تنموي جديد، تبدو النخب السياسية والثقافية والإعلامية وكأنها مكبلة بأنماط تفكير تقليدية، عاجزة تماماً عن مسايرة التحولات العميقة التي يعيشها المجتمع المغربي.
هذا التباين في الإيقاع، الذي وصفه الملك محمد السادس في خطاب العرش لعام 2025 بأن المغرب يسير بـ “سرعتين”، ليس مجرد خلل إداري أو تقني بسيط، بل هو أزمة رؤية وممارسة تلقي بظلالها على كافة مفاصل الحياة العامة. إننا أمام لحظة مكاشفة جماعية تفرض علينا إعادة تعريف دور النخب في مغرب يطمح إلى العدالة والفعالية.
في عقود مضت، كانت النخب السياسية تحمل مشعل الإصلاح والتغيير، لكننا نرى اليوم كيف تضاءلت تلك الطموحات وحل محلها نوع من “الواقعية” المفرطة التي تشبه الاستسلام. أصبحت هذه النخب تكتفي بالتقاط الإشارات الرسمية والتفاعل معها ببطء شديد، حتى القوى الديمقراطية التي كانت يوماً رائدة التغيير، وجدت نفسها متجاوزة بفعل الثقافة الرقمية الجديدة للمجتمع. فاليسار التقليدي بات يركز على التمثيلية المؤسساتية أكثر من الممارسة الديمقراطية الحقيقية، بينما تبخرت أحلام اليسار الجديد وسط صراعات الزعامات والطموحات الشخصية.
وفي مقابل هذا الركود، نجد أن المؤسسة الملكية قد تجاوزت الجميع بجرأتها في طرح القضايا الشائكة ورسم آفاق جديدة، بعيداً عن قيود الاصطفافات الحزبية الضيقة. لكن، يبقى الفساد المتجذر هو العائق الأكبر الذي يلتهم فرص التنمية ويحول المؤسسات إلى غنائم. ومن المؤسف أن نرى مسؤولين يبدأون مسارهم بفساد “صغير” ليتسلقوا الدرجات ويصبحوا “كباراً” فيه، بينما يظل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم وضوحه الدستوري، معطلاً في كثير من الأحيان أو يُعامل كخيار ثانوي لا كضرورة حتمية.
لقد تآكلت الثقة في النخب بشكل مقلق، فهي التي فشلت لعقود في إحداث التغيير المنشود، بل وتحولت في بعض الأحيان إلى عقبة في طريقه. وعندما تضعف الجامعة، ويتراجع التعليم، ويُخنق الإعلام المستقل، يصبح من الطبيعي أن تسيطر الانتهازية على الأحزاب وتنتج لنا نخباً مفلسة سياسياً وأخلاقياً.
المغرب اليوم في أمس الحاجة إلى “نخبة منتجة” تخلق القيمة المضافة في السياسة والاقتصاد والثقافة، نخبة تبتكر الحلول ولا تكتفي باستهلاك الريع والامتيازات. إن التحدي الأكبر ليس في غياب الرؤى الاستراتيجية، بل في ضعف النخب التي يُفترض بها أن تكون الجسر الرابط بين الدولة والمجتمع. لن نتمكن من الانتقال إلى السرعة القصوى إلا بثورة هادئة في العقول والسلوكات، تعيد الاعتبار للكفاءة والنزاهة، وتجعل خدمة الوطن غاية في حد ذاتها، لا مجرد وسيلة لتحقيق مآرب شخصية.